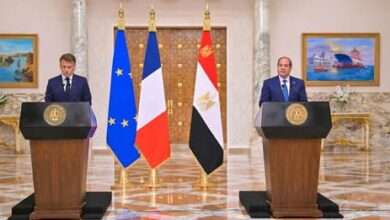الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور عبد الناصر سلم حامد يكتب : دارفور تُمحى.. كيف يُدار الموت كسلطة

في دارفور، لم تعد الحرب وسيلةً للسيطرة، بل وسيلةً لإلغاء الحاجة إلى السيطرة أصلًا.. لم يعد الموت في دارفور نتيجةً جانبية لانهيار الدولة أو لانفلات حربٍ أهلية ممتدة، بل تحوّل—منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023—إلى منتَجٍ سياسي مُصمَّم. ما يجري في الإقليم ليس انفجارًا عشوائيًا للعنف، بل منظومة حكمٍ بالعنف تعمل بمنطقٍ هندسي دقيق: تُحدّد الجماعات المستهدفة، وتختار الجغرافيا بوصفها مفتاح السيطرة، وتُعيد تنظيم الزمن ليغدو الحصار والتجويع أدوات قتلٍ بطيئة. هنا لا تُدار السلطة عبر المؤسسات، بل عبر التحكم في قابلية الحياة ذاتها.
بهذا المعنى، لا يمكن فهم ما يحدث في دارفور بوصفه أزمةً أمنية أو نزاعًا هامشيًا، بل كحالة متقدمة من العنف البنيوي؛ عنف لا يُنتج الأذى عبر القتل المباشر فقط، بل عبر تعطيل شروط الوجود الاجتماعي: الأسواق، المياه، الغذاء، العلاج، والحركة. المجتمع لا يُضرب في لحظة واحدة، بل يُحاصَر داخل بنيةٍ قسرية تُعيد إنتاج الهلاك يومًا بعد يوم.
أي إن العنف في دارفور لم يعد نتيجة فوضى أو انهيارٍ أمني، بل طريقة حكم تُدار عبر التحكم في شروط الحياة ذاتها: الغذاء، والحركة، والزمن الاجتماعي.
العنف هنا لا يعكس فشلًا في الحكم، بل نموذجًا لما يُعرف في علم الاجتماع السياسي بـ الحكم بالعنف، حيث تُستبدل أدوات السلطة التقليدية—القانون، والخدمات، والشرعية—بأدوات القسر: الخوف، والندرة، والتحكم في الحركة. وضمن هذا الإطار، لا تنهار الدولة فحسب، بل تنشأ سيادة بديلة تُفرض بالوقائع الميدانية وتُصان بالعنف المستدام.
في مستواها الأعمق، تتحول هذه السيادة إلى سيادة الموت؛ سلطة تُمارَس عبر تحديد من يستحق الحياة، ومن يمكن تركه للموت، ومتى، وبأي وتيرة. هنا لا تُنتج السلطة الحياة، بل تُدير الفناء، ولا تحمي الأجساد، بل تُصنِّفها وفق قابليتها للإزالة.
ضمن هذا المنطق، لا تعني الإزالة التهجير فحسب، بل تمثّل شكلًا من الإقصاء الاجتماعي الراديكالي. فلا يُقصى المجتمع من الأرض فقط، بل من المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي دفعة واحدة. لا يُسمح له بالبقاء، ولا بالعودة، ولا حتى بتمثيل ذاته في الفضاء العام؛ فيغدو الوجود الاجتماعي نفسه موضع نفي.
النجاح في هذا النظام لا يُقاس بعدد المواقع التي سقطت عسكريًا، بل بعدد القرى التي مُسحت، والأحياء التي أُفرغت، والطرق التي أُغلقت أمام الحياة. فالمدني لم يعد “غيرَ مقاتل”، بل هدفًا استراتيجيًا لأنه حامل البنية الاجتماعية: الأسرة، والسوق، والذاكرة، والمطالبة المحتملة بالعودة. واستهدافه هو استثمار طويل الأمد في تفكيك المجتمع.
وما جرى في الخرطوم لم يكن استثناءً عابرًا، بل نموذجًا أوليًا يُعاد إنتاجه اليوم، وبصورة يومية، في مدن دارفور الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
فالآليات ذاتها—الاقتحام، والنهب المنهجي، وترويع المدنيين، وتعطيل الخدمات، والسيطرة على الغذاء والحركة—لم تختفِ بخروج القتال من العاصمة، بل انتقلت جغرافيًا وتعمّقت بنيويًا. في دارفور، لم يعد هذا السلوك نتاج لحظة انفلات، بل ممارسة مستقرة تُدار باعتبارها أداة حكم يومية، تُحوِّل المدن من فضاءات عيش إلى مساحات خاضعة للضبط بالقوة.
في غرب دارفور، قدّمت الجنينة المثال الأوضح لهذا المنطق. ففي مايو–يونيو 2023، لم يكن العنف صدامًا أهليًا متبادلًا، بل عمليةً مركبة: استهداف أحياء محددة، ومطاردة المدنيين أثناء الفرار، وقتل واسع على طرق الهروب، ثم منع العودة وحرق القرى. هذا التسلسل ليس توصيفًا إنسانيًا، بل وصفة تشغيلية لإنتاج الفراغ السكاني وتثبيت واقع لا يحتاج إلى حكمٍ بقدر ما يحتاج إلى ضبط بالقوة.
وتكرّر النمط—مع اختلاف الكثافة—في مستري وكبكابية وأرينقا: اقتحام ونهب وقتل انتقائي، ثم إحراق شامل للمنازل والأسواق. والسوق هنا ليس فضاء تبادل فقط، بل عقدة حياة اجتماعية؛ وتدميره يعني تعطيل القدرة على الاستمرار حتى لمن نجا من القتل. فالنتيجة ليست نزوحًا فحسب، بل استحالة بقاء.
في وسط دارفور—زالنجي ومحيطها—اتخذ العنف شكلًا أقل صخبًا، لكنه أشد فتكًا بنيويًا. فُرض واقع قسري عبر اعتقالات عشوائية، واختفاءات قسرية، وتقييد حركة المدنيين، والاستيلاء على الممتلكات. وهذه الممارسات لا تهدف إلى الردع الآني، بل إلى خنق الحياة اليومية وتحويل البقاء ذاته إلى عبء نفسي واجتماعي يدفع إلى الرحيل.
أما الفاشر، فتجسّد أخطر أدوات هذه المنظومة: التجويع المنهجي بوصفه سياسة ندرة مُدارة. فلا يُحرَم السكان من الغذاء دفعة واحدة، بل يُدار تدفّقه بدرجات محسوبة؛ ويُشد الخناق ثم يُرخى جزئيًا لإبقاء المجتمع على حافة البقاء دون إنقاذ. وهنا لا يُدار الجوع فقط، بل يُدار الزمن نفسه، ويُعلَّق الزمن الاجتماعي: لا ماضٍ يمكن العودة إليه، ولا مستقبل يمكن التخطيط له، ولا حاضر مستقر.
الجوع، بهذا المعنى، هو اقتصاد قرار: من يتحكم في الغذاء يتحكم في الحركة، ومن يتحكم في الحركة يعيد رسم الخريطة البشرية. ويبدو النزوح خيارًا فرديًاد، لكنه في الحقيقة نتيجة هندسة قسرية تستبدل الإرادة الجماعية بمنطق النجاة الفردية.
ونتيجة لهذا النمط، أُجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح، وأُفرغت مدن وقرى كاملة من سكانها، لا كأثر جانبي للقتال، بل كغاية في حد ذاتها.
ويمتد هذا العنف إلى المعرفة والذاكرة؛ إذ تُستهدف شبكات التوثيق المحلية، ويُهجَّر الشهود، ويُكسر حضور الصحافة المحلية، فتتحول الجريمة إلى حدث بلا رواية. وهنا لا يُخفى العنف فقط، بل يُحتكَر تعريف الحقيقة، ويصبح النفي ذاته أداة حكم.
ويتقاطع هذا النمط مع خلاصات تقارير أممية وحقوقية متعددة وصفت ما يجري في دارفور بأنه هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، يتجاوز منطق الانتهاكات إلى منطق الإزالة.
ولمن يختزل ما جرى بوصفه عنفًا موجَّهًا ضد مكونات بعينها، فإن الوقائع تُفنِّد هذا التبسيط. فهندسة الموت لم تميّز هويّاتيًا حين تعارض الوجود المجتمعي المحلي مع منطق السيطرة. ففي شرق دارفور (أبو كارنكا)، وفي أجزاء من شمال ووسط دارفور، استُهدفت مجتمعات عربية بالنهب والإخلاء القسري والاعتقال التعسفي عندما رفضت الخضوع أو سعت إلى حماية أراضيها ومساراتها. وهذا الاستهداف العابر للهويات يعكس استراتيجية تفتيت الحقل الاجتماعي وكسر أي إمكانية لتشكّل تحالف مجتمعي جامع.
ولا تستطيع قوات الدعم السريع الادّعاء بأنها تمثّل دارفور أو “الهامش”، لا أخلاقيًا ولا تحليليًا. فالتمثيل—في علم الاجتماع السياسي—يقوم على حماية المجتمع وتمكينه، لا على تفريغه وتجويعه ومنع عودته. و“الهامش” مفهوم تحرّري يسعى إلى تفكيك الإقصاء التاريخي، لا خطابًا يُستخدم لتبرير الإزالة. وحين تُدمَّر الأسواق، وتُعلَّق حياة المدن، وتُكسَر الروابط الاجتماعية عبر القتل والتجويع، فإن ما يُمارَس هو حكم بالعنف لا تمثيل سياسي؛ فالأفعال، لا الشعارات، هي معيار التمثيل.
ولا ينفصل ذلك عن العنف الجنسي الذي يُستخدم بوصفه أداة لتفكيك إعادة الإنتاج الاجتماعي؛ إذ لا تدمّر الاعتداءات الضحايا فقط، بل تُعطّل انتقال القيم والعلاقات بين الأجيال، وتزرع الخوف والوصمة، وتُضعف قابلية العودة. والمستهدف هنا ليس الحاضر وحده، بل المستقبل الاجتماعي للمجتمع كله .
بعد القتل والتجويع وتفكيك الروابط، تأتي الحلقة الحاسمة: منع العودة. فالقرى المحروقة لا يُسمح لأهلها بالرجوع، والمناطق المُفرغة تُدار كواقع جديد. وهنا يتحول العنف من جريمة إلى نظام مستقر؛ فلم يعد القتل بالوتيرة نفسها ضروريًا لأن هدف الإزالة قد تحقق. وما يلي ذلك ليس صراعًا، بل إدارة لنتائج الصراع.
لماذا بلغ العنف هذا المستوى الآن؟ لأن لحظة الحرب الأخيرة أزالت القيود السابقة: تفكك الدولة، وتضارب الرعايات الإقليمية، وانشغال العالم بأزمات أكبر. وفي هذا الفراغ، صار الإفراط في العنف خيارًا عقلانيًا، لأن كلفته الدولية المؤجلة أقل من مكاسبه الميدانية الفورية.
الأخطر من الجرائم ذاتها هو الصمت الدولي حين يتحول إلى شراكة زمنية؛ فالإبادة لا تُنجز في لحظة، بل عبر الوقت، وكل يوم تأخير في التسمية والمساءلة هو مساهمة مباشرة في اكتمال المشروع.
الصمت هنا ليس حيادًا، بل قرارًا سياسيًا له كلفة بشرية واضحة تتراكم بمرور الوقت.
دارفور اليوم لا تشهد أسوأ ما في الحرب فحسب، بل أكثر ما فيها عقلانية وبرودة:
الموت قرار، والجوع أداة، والتهجير غاية.
ليست دارفور استثناءً تاريخيًا، بل مرآة لعالم يتعلّم كيف يُدير الموت بكفاءة، وكيف يحوّل الإبادة إلى إجراء، والتهجير إلى سياسة.
السؤال لم يعد: لماذا تُباد دارفور؟
بل: ما الذي أصبح ممكنًا في عالمٍ يسمح بذلك؟
إقرأ المزيد :